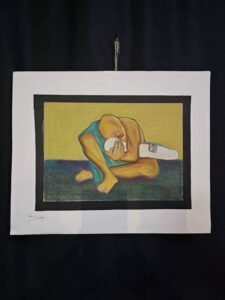#نادي_القراءة_مبادرةجسور
“لا تولد المرأة امرأة ..بل تصبح كذلك”
سيمون دوبوفوار
حول مفهوم الجندر و تاريخ الحركة النسوية .
قراءة في كتاب ( الجندر) للكاتبة عصمت حوسو تكتبها ل صدى الجنوب القارئة
حنان
__________________________
الجندر أو النوع الاجتماعي ويعني: “العلاقات والأدوار والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجل والمرأة مسبقًا في ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة.
إن مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي مفهوم حديث نسبيا فقد ظهر على الساحة الدولية منذ إعلان العام الدولي للمرأة 1975 وترسخ خلال العقد الدولي للمرأة 1985 فبرزت الاهتمامات بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة بين الرجال والنساء في العديد من المجالات
لكن مما يلفت الإنتباه فعلا هو ذلك الإجماع الكامل من الفلاسفة وعلماء الاجتماع على دونية المرأة بدءا من الفلاسفة الأوائل افلاطون وارسطو وسقراط و حتى أواخر القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين مرورا ب أوغست كونت و هوبز وسارتر ودوركهايم و غيرهم
حيث اعتبر على الدوام النشاط الذي تقوم به الانثى أقل شأنا من النشاط الذي يقوم به الذكر .
وبحسب الكاتبة عصمت حوسو:
يرى أرسطو مثلا بأن المرأة هي تشويه للإنسانية، وأن دونية المرأة هي نتاج لطبيعتها البيولوجية ووظيفتها فقط هي الإنجاب
ولم يختلف الحال لدى سقراط الذي يرى بأن المرأة هي” الشجرة السامة” .
فيما كان أفلاطون يأسف بأنه ابن امرأة وظل يزدري أمه لأنها أنثى، وعلى المجتمع أن يكافىء الرجال المحاربين بأن يمنحهم نساء كمكافأة على شجاعتهم،و اعتبر أفلاطون أن المرأة شريرة بطبيعتها، فالآلهة صنعت رجلاً كاملاً شرط أن يحافظ على كماله، وإذا اخل فإنه يعاقب بأن يولد مرة ثانية في صورة امرأة.
اما جان جاك روسو(1712-1778) أحد أهم فلاسفة التنوير فقد كان يعتبر المرأة مخطئة إذا حاولت أن تشكو من ظلم اللامساواة التي فرضها عليها الرجل.
و أنها مصدر للشر والخطيئة وأن عليها أن تكون خاضعة للرجل و ملبية لرغباته في المتعة كما يجب أن تكون مغرية ومثيرة، و في الوقت نفسه عليها أن تكون مسؤولة عن السيطرة على رغباتها اللامحدودة (ويقصد الحشمة والعفة) ………
هل اختلفت وجهة نظر علم الاجتماع كجزء رافد للفلسفة في نظرته للمرأة ؟؟
بحسب مؤسس علم الاجتماع أوغست كونت ( 1798-1857)
فإن المرأة خاضعة للرجل واستمرار سلطة الذكر هو الذي يصنع نظام اجتماعي مستقر، ذلك أنه _ وبحسب رايه_ يتصف الرجال بالنبل – السمو- القوة والحزم – التفكير العميق- الالتزام بالمبادىء.
وأما المرأة فتتصف بالرقة- الحنان- الجمال- التعاطف- والشفقة.
وقبله نجد ابن خلدون الذي لفت الى ان الاختلاف في توزيع القوة والسلطة والامتياز في العالم يضطر بالاضعف لتبني مفاهيم الاقوى وربما طرحت هذه المقوله لتعالج مصالح القوى السياسية الا انه يتم توظيفها لتبرير دونية المرأة انطلاقا من من أنها مضطرة لضعفها القبول بتسلط الرجل والخضوع مما أفقدها الكثير من الحقوق الإنسانية، يظهر ابن خلدون نتيجة لما سبق أن المجتمع قائم على الذكور وان جميع نظرياته لا تنطبق إلا على مجتمع الذكور فقط، وان المراه جنس آخر لا وجود لها في مجتمعه، كما لو أنها مجرد وسيلة لإشباع شهوات رجال السياسة الأمر الذي يؤدي برأيه إلى انهيار الدولة
إذ يقول” إن الإكثار من النساء والشراب يؤدي إلى انهيار الدولة”
…
النسوية..ومنجزات الحداثة.
لعل هذا الإرث الثقيل والمتراكم من التمييز والتحيز ضد المرأة قد مهد الطريق لظهور ما يسمى بالحركات النسوية والتي ظهرت على شكل ثلاث موجات
بدأت الموجة الأولى:
كحركة اجتماعية سياسية عملت على رفع الصوت والمطالبة بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل لكنها حاولت الاقتراب من النموذج الذكوري السائد كمعيار ونموذج حضاري للإنسان أكثر منها تأكيدا على أحقية الأنثى بأن تكون مكانتها مساوية للرجل
حيث دأبت على تأكيد المساواة بين الجنسين و المطالبة بحقوق المرأة العاملة التي يتمتع بها الرجل وكان ذلك في ظل الحرب العالمية الأولى
الموجة الثانية:
كانت في ستينيات القرن الماضي في أمريكا حيث اشتد عود الليبرالية الأمريكية التي تدعو الى المساواة في الحقوق وتقويض الصورة النمطية للأنثى لاسيما بعد النجاحات الهامة في محاربة العنصرية و مظاهرات طلاب الجامعات الشهيرة عندما قاموا بحرق الكعوب العاليه و مشدات الصدر و التنديد ضد مسابقات ملكات الجمال وكل ما يحصر الانثى بانوثتها فقط،
//وهنا تجدر الاشارة إلى أن المرأة في الأقطار العربية كسوريا ومصر وتونس كانت قد حصلت على بعض الحقوق العامة مثل حق الاقتراع و التمثيل السياسي كذلك قطعت أشواطا في التعليم والعمل المهني والأجر المتساوي//
إن أهم ما ميز الحركه النسويه الثانية أنها كانت اكتشافا وبلورة لمفهوم (الأنثوية), أما الفرق بين الموجتين الأولى والثانية هو أن الأولى تُعتبر إحدى تجليات الحداثة التنويرية التي كانت تجسيدا للمركزية الذكورية حيث طمست خصوصية المرأة وقربتها من النموذج الذكوري. أي أن نضال المرأة كان في المساواة مع الرجل بأن تصبح مثله ( الرجل هو المعيار)
أما النسوية الثانية فأبرز ما يميزها هو نقد النموذج العقلاني الذكوري للإنسان ورفض انفراده في الميدان كمركز للحضارة فهي تختلف وتتناقض مع الأولى بتأكيدها على اختلاف النساء عن الرجال
ظهرت بعد ذلك حركة ما بعد النسوية أو الموجة الثالثة:
حيث تميزت بتأثر رائدات الحركات النسوية بآراء فلاسفة ما بعد الحداثة مثل فوكو ودريدا وقد شكل نقد هؤلاء الفلاسفة لمفهوم العقلانية و لمركزية العقل حلقة الوصل بين الفكر النسوي وفكر ما بعد الحداثة وحفزت آراء فوكو المفكرات على تقديم المذهب النسوي على أنه علم مواجهة يتحدى حصر الإنسانية بالذكر والتعريف الجندري للذكورة وتعتبر ما بعد الحداثة أحدث حلقة من حلقات التنوع في ملامح الفكر النسوي الذي يتسم بالتحول والتغير المستمر
//لقد اتُهمت النسوية بأنها اعتبرت جميع النساء واحد،//
اي أن أي صفة تمتلكها امرأة ما هي بالضرورة صفة لجميع النساء
وهذا يعود لأن المجتمع يعتبر الانوثة جنسا واحد، ونوعا واحدا وشعورا واحدا، على النقيض من الرجال الذين يتصفون بالتنوع والتعدد.
لذلك فإن النسوية الثالثة تجد بأن “الثقافة الذكورية المركزية تحرم الأنثى من التنوع و الاختلاف”.كما تقول ( جوديت بيتلر )
كل تلك الآراء مجتمعة تذكرنا بأهمية التحليل الجندري
وتذكرنا بأهمية ارتداء النظارة الجندرية للغوص أكثر بالتفاصيل والنظر في عمق المفاهيم لندرك بأن الجنس طبيعة بيولوجية ثابتة في البيئة والوراثة أما الجندر فهو ليس طبيعة بيولوجية وإنما نتيجة لسيرورة اجتماعية تحدد الأدوار والسمات وهو متغير و مكتسب اجتماعيا وثقافيا.
..
إن التصورات المتحيزة في عقولنا تجعلنا نقسم العالم إلى قسمين متعاكسين يؤدي بنا إلى ترسيخ الاستقطاب الجندري بحيث نتجاهل الفرق بين الجنس الواحد و نضخم الفروق بين الجنسين الأمر الذي يخلق فجوة غير حقيقية بينهما. وتصور الرجل والمرأة كما لو أنهما طرفا نقيض ولا بد لأحدهما أن يتفوق على الآخر.
وأن العدالة الجندرية لا تعني الدعوة لأن يكون الجنسان متماثلين، وإنما إلى إزالة المفاضلة بينهما حتى لو كان الجنسان مختلفين في أدوارهما وصفاتهما؛ فلا وجود لجنس يولد متفوقاً ومتميزاً على الآخر. وإن تحقيق العدالة الجندرية يتطلب تغييراً في ممارسات التنشئة الاجتماعية بدءا من المنزل والمدرسة وصولا إلى الإعلام و كافة مؤسسات المجتمع