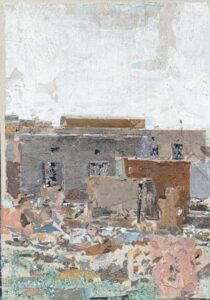الزمن في اللغة العربية غيره في نحوها وقواعدها، اللغة تستطيع أن تعبر عن مختلف أشكال الزمن ومفاهيمه، لكن النحو العربي لا يعبر إلا عن الزمن الخطي (ماض، حاضر، مستقبل) ومرد ذلك برأينا أن عصر تقعيد اللغة (القرن الثاني الهجري) كان عصرًا لا يستطيع الفكر الإنساني حينها أن يرى الزمن إلا بهذا المفهوم (المفهوم الخطي للزمن) وهي صيغة متقدمة حينها (أوغسطين جاء بعد قرون ليتحدث عن الزمن بطريقة قبل وبعد أي صيغة خطية للزمن ونيوتن يتحدث عن الزمن بلغة الرياضيات والفيزياء لكن أيضًا زمنه خطي) إذن الفكر الإنساني عمومًا والعربي حصرًا في عصر التقعيد لم يكن يستطيع أن يستنطق اللغة ليخرج منها صيغ قواعدية للزمن غير الزمن الخطي، ولذلك نحن نثمن ونقدر الجهد العظيم الذي قدمه فقهاء اللغة في ذلك العصر، لكن! آن الأوان لنعيد النظر به.
لا يتسع المجال هنا لتقديم طرح لتطور مفهوم الزمن في الفكر الإنساني، فالفلسفة ليست ميداني (وأنا الذي أصوب وأسعى دومًا لتصويب مفاهيمي اللغوية بالفلسفة وليس بغيرها) كما أني سأعفي نفسي وأعفي القارئ الكريم من التشتت والابتعاد عن ضالّة المقال، فضالّتي هي باختصار: اللغة تستطيع أن تعبر عن الزمن بمختلف مفاهيمه، لكن النحو لا يعترف إلا بالزمن الخطي فكيف يمكن أن نعيد النظر لنجعل النحو نحوًا معاصرًا يتماشى مع تطورات الفكر الإنساني المعاصرة من جهة ويتماشى مع واقع الحال للدلالات الاشتقاقية للغة من جهة ثانية ؟
1-في الزمن النحوي (الزمن كما يظهر في النحو):
ينفي الفقهاء ظهور الزمن إلا بالأفعال وبعض الكلمات التي تدل على الزمن مثل ساعة وشهر وصباح ومساء إلخ..وهي بمعظمها تندرج تحت تصنيف ظرف الزمان.
فهم ينفون نفيًا تامًا تعبير الأسماء أو احتوائها على زمن، فالاسم بالتعريف هو كلمة تدل على معنى لا يحتوي حدثًا أو زمنًا، حتى تلك الأسماء التي تدل على حدث، فهي تدل على حدث لكن دون الدلالة على الزمن كالمصادر، فالمصدر بتعريفه أنه يدل على حدث لكن دون زمن.
أزمنة الأفعال في النحو هي كما أسلفنا: ماض، حاضر، مستقبل، فلا وجود لأزمنة تعبر عن مفاهيم الزمن المختلفة، فالنحو لا يرى الزمن المستمر (الزمن الدائري)، ولا يرى الزمن المطلق (الزمن الذي يتراكب ويتحد فيه الماضي والحاضر والمستقبل) فهل يمكن فعلًا أن نستخرج من اللغة صيغ اشتقاقية قياسية تعبر عن الزمن المستمر والزمن المطلق؟
الفكر الإسلامي في مرحلة التقعيد كان يقسم الزمن إلى حدين: الزمن في الحياة الدنيا، وهو زمن يتجه من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل وصولًا لقيام الساعة. والزمن في الحياة الآخرة، وهو زمن أبدي سرمدي، وتعبير أبدي سرمدي (ويضيفون أحيانًا كلمة أزلي) هو تعبير لا يميز بين المستمر والمطلق، يخلط المستمر بالطلق، فهو مطلق ومستمر بآنٍ معًا، وهذه الارتكازة في الفكر الإسلامي (دنيا، آخرة) هي في تقديرنا التي جعلت فقهاء اللغة لا يرون الصيغ القياسية والاشتقاقية للزمن المستمر والزمن المطلق فهما زمنان غير دنيويين حسب المعتقد الإسلامي وبما أننا لازلنا نعيش على الأرض (الحياة الدنيا) فالزمن هو زمن أرضي خطي انسيابي ينساب من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل وصولًا إلى قيام الساعة التي فيها يتغير مفهوم الزمن.
والسؤال الآن: هل اللغة العربية تحتوي على صيغ اشتقاقية قياسية (يمكن القياس عليها) تعبر عن الزمن المستمر والزمن المطلق؟
جوابي الشخصي عن هذا السؤال وبدون تردد: نعم!
2-الزمن اللغوي (الزمن كما يظهر في اللغة)

إن صيغ اسم الفاعل واسم المفعول ( وهي صيغ قياسية تمامًا) تعبر عن الزمن المستمر كما أن صيغ المبالغة من اسم الفاعل تعبر عن الزمن المستمر، والزمن المستمر هنا هو مستمر بمعنى تكراري، وليس كما يظهر باللهجات العامية أو في اللغات الأخرى كالانكليزية او الفرنسية، فنحن نقول بعامياتنا (عم يكتب) عامية شامية أو (بيكتب) عامية مصرية لنشير إلى زمن هو حاضر مستمر وسيبقى مستمرًا لحين الانتهاء من الكتابة، على حين الزمن المستمر في صيغة اسم الفاعل واسم المفعول هو زمن مستمر تكراري دائري، بمعنى أن الفعل تكرر في الماضي ويتكرر في الحاضر وسيتكرر في المستقبل بالطريقة نفسها لذلك وصفناه بأنه تكراري دائري، وهذه ميزة مهمة لأنها تعبر عن المفهوم الثاني للزمن وهو مفهوم الزمن الدائري، فالزمن حتى الآن له ثلاثة مفاهيم (خطي ودائري ومطلق) وجميعها ترتبط بالحركة على حين الزمن في النحو لا يقبل إلا الزمن الخطي بعد أن يفصله عن الحركة.
وصيغ المصدر باختلافاتها (صريح وميمي ومؤول) تعبر عن الزمن المطلق، فنحن نقول: كاتب، لندلل على حدث يحصل باستمرار هو حدث الكتابة، ونقول كتابة(مصدر كتب) لندلل على حدث زمنه مطلق يتحد فيه الماضي بالحاضر بالمستقبل، فحدث الكتابة هي كتابة في الماضي وكتابة في الحاضر وكتابة في المستقبل وكتابة فيهم جميعًا معًا، وإذا تبين أنه ليس حدث كتابة لسبب من الأسباب (تبين خطأ ما يجب تصحيحه) فهو ليس كتابة في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، وهذه ميزة الزمن المطلق تستطيع تصحيح الماضي والمستقبل انطلاقًا من اللحظة الراهنة، واللحظة الراهنة في الزمن المطلق هي لحظة وهمية افتراضية لا يمكن تعيينها واقعيًا (حسيًا)، إن هذه المعاني للزمن المطلق تتضمنها صيغة المصدر، لكن لم يتح لأئمة اللغة التقاطها، فرحّلوها لزمن الآخرة دون أن يلتقطوها فعبروا عنها بتعبير السرمدي الأبدي.

في صيغة اسم الفاعل يقول فقهاء اللغة إنها صيغة تدل على صاحب الفعل، ويسكتون عن الفعل نفسه، وأنا أعترض على هذا السكوت، فصاحب الفعل لم تتم الدلالة عليه من خارج الفعل، إنما تمت الدلالة عليه من الفعل وقدرة فاعله على تكراره، فكلمة كاتب دلت على صاحب فعل الكتابة لكن بدلالة تكراره لفعل الكتابة، وإلا لما كانت الدلالة صحيحة أو كافية، فهي تدل على شخص يقوم بفعل الكتابة بشكل مستمر، قام به في الماضي ويقوم به في الحاضر وسيقوم به في المستقبل، والفرق بين المستمر والمطلق أن المستمر لا يمكن أن نصحح ماضيه أو مستقبله, وهكذا الأمر في صيغة اسم المفعول التي تدل على استمرار وقوع الفعل على المعني بالكلام، فنقول مثلًا: فلان مذموم، أي أن فعل الذم يقع بشكل مستمر على فلان، وفلان هنا هو بموقع نائب الفاعل فهذا صيغة المبني للمجهول من المستمر.
لم يستطع فقهاء اللغة في عصر التقعيد أن يروا الزمن المستمر أو الزمن المطلق، ذلك أن مفهوم الزمن المستمر(التكراري الدائري) يختلف عن مفهوم الزمن الانسيابي الخطي، والزمن المطلق هو تجاوز للزمنين (الخطي والدائري) معًا، فهو لحظة تتركز فيها كل الأزمنة وتتحد لتعبر عن مطلق الزمن، فجاء النحو العربي بهذه الصيغة الموجودة والتي أصبحت صيغة مقيدة للغة وللفكر معًا، فاللغة هي أداة الفكر ومحتواه، والنحو هو شرع اللغة وقوانينها، والقوانين التي لا تتماشى مع واقع الحال وراهنية الفكر الإنساني هي قوانين يجب إعادة النظر فيها، إن المغالطة الخطيرة التي كشفها تطور العلوم اليوم تكمن في أن النحو يفصل بين الزمن والحدث (الفعل, الحركة) فعندما نعرف المصدر على أنه يعبر عن حدث بدون زمن، فهذه مغالطة لا يمكن السكوت عليها، لا يمكن فصل الزمن عن الحركة (الحدث، الفعل) فمناط الزمن هو الحركة، التحرك، الفعل، الحدث. وهذه المغالطة مردها بتقديري إلى مفهوم الزمن في الفكر الإسلامي في مرحلة التقعيد.
بقي أن ننوه أن الزمن في كل مرحلة من مراحل اللغة هو الزمن الموعى بدلالة هذه اللغة في تلك المرحلة، وليس الزمن الموضوعي، فالزمن الموضوعي خارج اللغة دومًا، والذي نجده في اللغة هو الزمن الموعى، بالتالي فإن الزمن في اللغة لا يمكن وعيه بدلالة اللغة وحدها، إنما بدلالة المنتج الفكري والعلمي الذي حققه العقل والفكر البشري، وعليه فإن الفقهاء استطاعوا التقاط الزمن وصيغه الاشتقاقية في اللغة بموجب ما وصل إليه الفكر بعصرهم. وهذا ما يجعلنا نسأل: إن الفكر البشري حقق قفزات متقدمة جدًا عما كان عليه في عصر التقعيد أفلا يدعونا هذا إلى إعادة النظر بالنحو؟